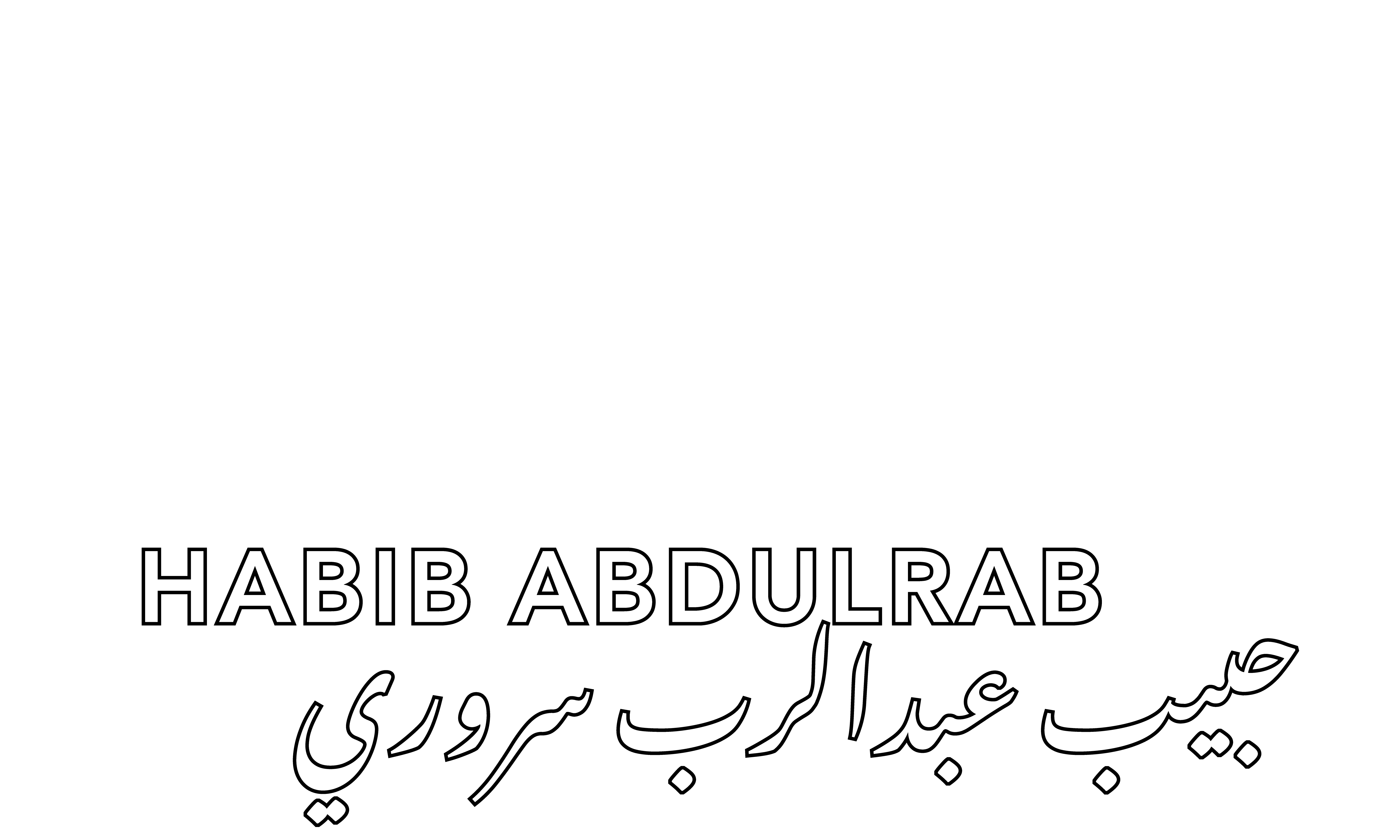ما الذكاء؟
حبيب سروري
«لي المشورةُ والرأيُ، أنا الفهمُ، لي القدرة»
سِفر الأمثال، 8.14
كلمة «الذكاء» بالعربية، ومرادفتها اللاتينية Intelligentia، تترجمان كلمةً إغريقيةً Noûs، تعني: رؤية العقل. لِـهذه الرؤية في الفلسفة الإغريقية منظوران مختلفتان:
في حين يرى أفلاطون أن الذكاءَ تجَلٍّ نورانيٌّ متّصلٌ بعَالمٍ مثاليٍّ ميتافيزيقيٍّ، يعتبر أرسطو الذكاءَ ابن الحسّ والتحليل والتفنيد.
لعلّ الرؤية الافلاطونية تجسيدٌ لأسطورةٍ إغريقيّةٍ بطلها بروميثيوس الذي انتزع النار من الإله زيوس، ليمنحها للبشر. النارُ هنا رمزٌ للذكاء والمعرفة، لِشرارة الوعي والمقدرة على البحث والخلق والإبداع.
عُوقِبَ بروميثيوس لذلك بشدّة، كما عُوقِب آدم وحواء في الميثولوجيا الدينية لقطفِهما تفاحة شجرة المعرفة والوعي والإدراك، وكسرِهما، مثل بروميثيوس، سياجَ النظام الإلهيّ المغلق الذي يفرض الطاعة العمياء، ويمنع تحرير الإنسان وتوسيع دوائر معرفته.
انبثقتْ، انطلاقاً من المفردة اللاتينية Intelligentia، كلمةُ Intelligence بالفرنسية، ومثلها كلماتٌ شبيهةٌ في اللغات الأخرى ذات الأصول اللاتينية مثل الإسبانية والإيطالية. ثمّ انتقلتِ الكلمة الفرنسيّة، كما هي، إلى الإنجليزيّة.
اشتُقَّت الكلمة اللاتينية من فعل intelligere المشتقِّ بدورِهِ من inter (بين)، وlegere (يلتقط، يختار… التي انضاف لها لاحقاً: يقرأ)، لِتدلَّ على ملَكة التفنيد والتمييز بين الأشياء.
فيما جذر كلمة «ذكاء» بالعربية فعلُ: «ذكا»، ذو المعاني المتعدِّدة. (ذكت النار: اشتدّ لهيبها. ذكت الشمس: اشتدّت حرارتها. ذكا المسك: طابت رائحته) … حيث «الذكاءُ» في الأصل: لهب النار، الجمرة الملتهبة.
وُلِد المدلولُ العربيّ الحديث لِكلمة «ذكاء»، انطلاقاً من ترجمات روّاد عصر النهضة العرب للمفردة الفرنسية-الإنجليزية Intelligence، في القرن 19، لِيتقاطعَ مع مدلول مفهوم «العقل» كما أرساهُ عصر الحداثة الأوربيّة: المقدرة على الاستيعاب والتعلّم والفهم والاستنتاج والتحليل والتمييز والاستنباط والتكيّف وحلّ المسائل وصناعة المعارف…
بجانب ذلك، تحتضن كلمة «ذكاء» ضِمناً معانٍ عربيّةً لِكلماتٍ عريقةٍ في غاية الجمال، كالفطنة والفراسة والألمعيّة، كانت سائدةً قبل ولادة كلمة «ذكاء».
ناهيك عن أن الترجمات العربيّة المعاصرة جعلتها تحتضن كلمات أخرى، مثل smart «أنيق»، في حال الهواتف الجوّالة smartphone، التي تُترجَمُ بـ «الهواتف الذكيّة»!
كان بودّي، كما سيفعل أي باحث أجنبيّ في اللغة أو علوم الاجتماع والتاريخ، في هذه اللحظة من دراسته، أن استخدمَ برمجية نغرام Ngram غوغل لرسم المنحنيات البيانيّة المقارِنة بين عدد استخدامات: «ذكاء» ومرادفاتها، في كل الكتابات العربية منذ قرون، لنستشفّ عبر هذه المنحنيات أضواءً في غايةِ الأهميّة حول كل التداخلات والتغيّرات والتطوّرات في مداليل هذه المفردات عبر الزمن، وذلك لدراساتٍ متنوّعَةٍ لغويّةٍ واجتماعيّةٍ وتاريخيّة.
لسوء الحظ، لا يمكن ذلك في لغتنا العربية، لعدم امتلاكنا بنك لغة: مدوّنة Corpus، جديرة بهذه التسمية اليوم، تحتوي على معظمِ ما كتب بلغة الضادّ.
المقارنةُ عبر الزمن منذ قرون، بالفرنسية مثلاً، بين عدد استخدامات المترادفتين Intelligence و Entendement، مفيدٌ جدّاً ومنيرٌ في أكثر من مجال، لاستيعاب أسباب «انتصار» الكلمة الأولى على الثانية، حسب تعبير البروفيسور ويليام ماركس.
لنلاحظ الآن أوّلاً: لا يُعتبر الذكاء، بمدلولهِ الحديث، ملَكةً للإنسان فقط، لا سيّما بعد منتصف القرن التاسع عشر، إثر اقتحام نظرية التطوّر الداروينيّة وعلوم الدماغ للعِلم الحديث. لأن الإنسان اليوم، من المنظور العلميّ المتحرِّر من أيّ مسلماتٍ دينية، جسدٌ لا غير، كلّ نشاطاته الروحيّة (اللغة، الذاكرة، التفكير، الذكاء، الوعي، اللاوعي…) لها تاريخٌ تطوريٌّ، ومركزها الدماغ. وكذلك حال موقع وتاريخ الذكاء الحيوانيّ عامّةً.
لعلّ ذلك ما يفسِّر أن كلمة Entendement التي كانت حتى بداية القرن 19 أكثر استخداماً من Intelligence بالفرنسية، كما توضح ذلك منحنيات برمجية نغرام، صارت اليوم أقلّ من الثانية بكثير؛ كون هذه الكلمة الأخيرة ذات أبعادٍ أوسع، ترتبط بأشكال مختلفة من ذكاء الكائنات الحيّة، ومن أنماط مختلفة من الذكاء العلميّ أو الاجتماعيّ أو اللغويّ أو العسكريّ وغير ذلك، ومن تحوّل ملَكة الذكاء من كينونةٍ إلهيّةٍ سابقاً، إلى كينونةٍ مستقلَّة، يمكن نقلها إلى الآلة اليوم، في عصر صناعة الذكاء.
لنلاحظ ثانياً: تبدو لأصول كلمة «الذكاء» في العربية نكهةٌ أفلاطونيّة إشراقيّة نورانيّة، فيما لأصول كلمة Intelligence (المرتبطة في جذر تكوينها بالتمييز والاختيار) بُعداً منهجيّاً تحليليّاً أرسطويّاً، قاد اليوم إلى مفهوم «الذكاء الاصطناعيّ» باعتبارهِ آلةً لصناعة الذكاء بمعناه الحديث: للتدرّب على التعلّم والفهم والتحليل والاستنتاج والحوار وتوليد المعارف وحلِّ الإشكاليات (كما تحدّثنا عنه في مقالٍ سابق في «القدس العربي» بعنوان: «فلسفة الذكاء الاصطناعيّ»).
بيد أن لِلمدلول الأرسطويّ للذكاء Noûs فلاسفتَه العرب أيضاً، لا سيّما رمز هذه المدرسة: ابن رشد الذي طوّر المفهوم الأرسطويّ، وأضاف له تجديداتٍ جذريّةً، لا سيّما حول مفهوم «العقل الفعّال»، كعقلٍ كونيٍّ يشترك فيه البشر جميعاً، يمكن اكتسابُهُ عبر «العقل المتفاعِل» المتّصل بالعقل الفعّال.
رفضَ توما الأكويني ذلك بضراوة في كتابه «عن وحدة العقل: ضدّ الرشديين» في 1270، ومعه كنيسة القرن الثالث عشر التي أدانت النظرية الرشديّة كونها تتعارض مع العقيدة المسيحية.
اختفت هذه النظرية بعد ذلك، قبل أن تعودَ من جديد، وتفرضَ تأثيرها على فلاسفة الحداثة لاحقا، مثل كارل ماركس صاحب مفهوم «العقل الجمعي» Intellect général الذي استخدمهُ كتعبيرٍ عن احتواء الآلة اليوم للخبرة والمعارف البشرية في العلوم والتنظيم والتقنيات.
انتقد كارل ماركس تناقضَ هذا الذكاء الجمعيّ، كونه انتاجَ عملِ البشريّة عموماً من ناحية، فيما ملكيته تظلّ خاصّةً لرأس المال.
بطبيعة الحال، لا يبتعد اليوم مفهومُ «الذكاء الجمعيّ» الماركسيّ، وريثُ العقلِ الكونيّ الفعّالِ الرشديّ، عن مفهوم «الذكاء الاصطناعيّ».
لاحظ كثيرٌ من المفكرين (مثل ارنست رينان في القرن 19، والبروفيسور جون باتيست برونيه في محاضرته الطازجة، في 17 أكتوبر 2025، في كوليج دو فرانس: «ابن رشد، ماركس، والجنرال الذكاء») أن ابن رشد سبق الحداثة الأوربية في ذلك.
كذلك يمكن اعتبار صاحب «لا إمام سوى العقل»: المعرّي، الذي مارس النقدَ الصارمَ لكلِّ طوائف ومدارس وأديان زمانه، سابقاً لِعصرِهِ بطريقتهِ الخاصة التي يصعبُ وضعُها عادةً في هذه المدرسة الفكريّة أو تلك، والتي تنسجمُ أكثر من غيرها مع عصرِ الحداثة، هو الذي اعتبر العقلَ (منبع تجليّاتِ الذكاء) منفصلاً كليّةً عن الدين (ابنُ الوحي الميتافيزيقيّ)، مُمارِساً تجاه أطروحاتهِ اللاهوتيّة نقداً لا هوادة فيه.
ألم يقل:
اثنانِ أهلُ الأرضِ ذو عقلٍ بلا دينٍ وآخرُ دَيِّنٌ لا عقلَ له
هو الذي أخضعَ أيضاً، لِسلطةِ العقلِ، الضميرَ والأخلاقَ كغايةٍ بحدِّ ذاتها، بعيداً عن المفهوم النفعيّ السائد لأخلاق البقّالين: أخلاق الحسنات والسيئات؟
ختاماً، ليس مجال الحديث هنا عن البناء التحتّي في خريطة عصبونات الدماغ البشريّ للذكاء، باعتبارهِ منظومةً متكاملةً تشملُ ملَكاتٍ دماغيةً متعدّدة، ومناطق عصبونيةً متنوِّعة مثل منطقة «الفصّ الجبهيّ» المرتبطة بالإدراك والاستبطان وما وراء المعارف: «المعارف حول المعارف»، التي عرفتْ تطوّراً حديثاً هائلاً مع بدايات الإنسان الحديث (هوموسابيان) قبل حوالي 300 ألف سنة، لا سيّما عقب ما تسمّى: «الثورة الإنسانية»، قبل حوالي 50 ألف عام، عندما تفجّرت خلالها كلُّ ملَكاتِه الحديثة الكبرى، ومواهبِهِ الفنيّة ومعتقداته الدينيّة، وسادَ العالَم: تضاعف حجم «الفصّ الجبهيّ» 30 مرة!
تطرّقتُ إلى هذه القضايا في كتابنا المشترك، مع الفيلسوف موليم العروسي، الذي سيصدر قريباً جدّاً عن منشورات المتوسط، بعنوان: «الذكاءُ الاصطناعيّ، الروح/الدماغ، ووهمُ العقل العربيّ».