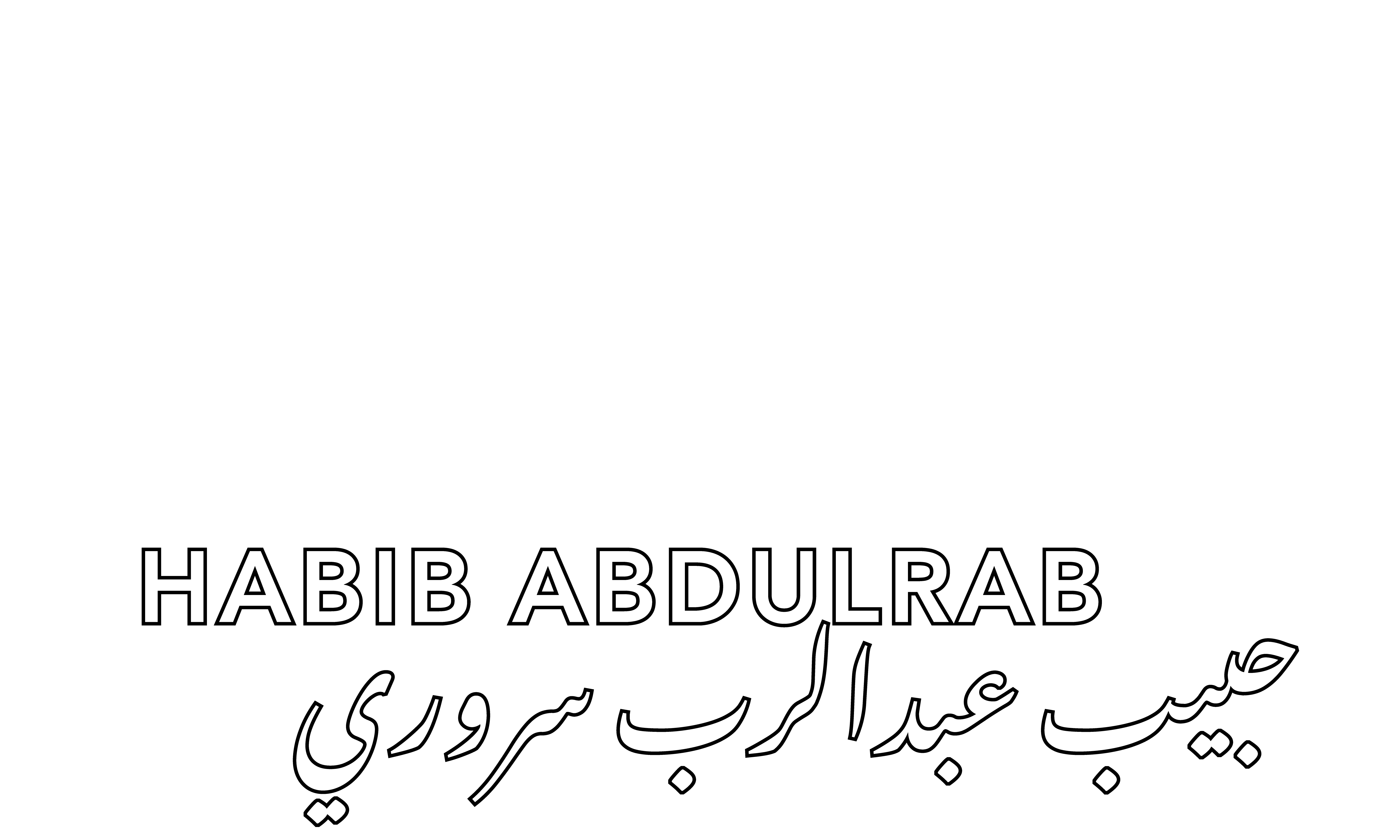فلسفة الذكاء الاصطناعي
حبيب سروري
فلسفة الذكاء الاصطناعي فرعٌ من فروع الفلسفة يدرس المفاهيمَ الجوهريّة التي يتأسّس عليها علم الذكاء الاصطناعي:
1) علاقته بالتفكير والحوسبة calculabilité (أي: ما الذي تستطيع الآلة حسابه وإنجازه، وما الذي لا تستطيع)؛
2) ماهية الدماغ وهل يمكن اعتباره «آلة بيولوجية» يمكن حوسبتها؛
3) مستقبل الذكاء الاصطناعي وسؤال إمكانية تجاوزه للإنسان في كل المجالات…
وغير ذلك من القضايا النظرية والتقنية.
قبل أن نتناول القضية الأولى، نحتاج أن نُذكِّر ما تعني كلمة «خوارزمية» (المشتقّة من اسم مولانا محمد بن موسى الخوارزمي) التي اكتسحت حياة البشر منذ العقود الأخيرة، وصارت ربما أكثر الكلمات حضوراً وإشعاعاً. يسمع بها ويتعلّم مدلولَها الأطفالُ منذ أوّل عامٍ دراسيّ.
هي، بتبسيطٍ مقتضب: مجموعةُ خطوات دقيقة مرتّبة يلزم التقيّدُ بها، لحلّ مسألة أو لإنجاز مشروع: وصفةُ طبخ؛ طريقةٌ لِمعرفة هل العدد زوجي أم فرديّ (يكفي قسمته على 2، فإذا كان الباقي 1 فهو فرديّ ما لم هو زوجي)؛ لِترتيب كتب المكتبة حسب الحروف الأبجدية؛ لِجدولة مهام مشروع بناء عمارة؛ أو لِتسلسل عرض منشورات الفيسبوك على المستخدِم…
نحتاج ثانيا للتذكير بما تعنيه «ماكينة تورنغ».
هي ماكينةٌ نظريّةٌ بسيطةٌ جدا اخترعها في منتصف الثلاثينات آلان تورنغ Turing (مؤسس علوم الكمبيوتر وأب الذكاء الاصطناعي أيضا؛ ومخترع ماكينة إينجما التي فكّت شفرات برقيات جيوش النازية، وساهمت في التعجيل بهزيمتها).
هي النموذج الأساسيُّ لكلِّ ما يستطيع عملَه الكمبيوترُ الذي اُختُرِعَ في الأربعينيّات من وحيِها: أيُّ برنامجٍ يمكن تصميمُه لِلكمبيوتر، يمكن برمجتُه أيضا في ماكينة تورنغ.
قبل الدخول في العلاقة بين التفكير والحوسبة والكمبيوتر، يلزم الإشارة إلى أن من أهمِّ اكتشافات العِلم في القرن العشرين مفهومَ «عدم قابلية الحلّ» indécidabilité الذي أكتشفه وبرهنهُ عالِم الرياضيات غودل Gödel، وبرهنهُ بطريقتين مختلفتين العالمان تشرش Church، وتورنغ نفسه.
قبل غودل كان الجميع يعتقد أنه يمكن حلُّ أي مسألةٍ رياضيّة إيجاباً أو سلباً (أي برهنة أنها صحيحة أو خاطئة).
برهن غودل أن هناك خياراً ثالثاً: في أيِّ منظومةٍ منطقيةٍ رسميّة formel، ثمّة مسائل لا يمكن تقرير أنها صحيحةٌ أو خاطئة!
لعلّ المثل التبسيطيّ جدا لذلك في لغتنا اليومية عبارة: «هذه الجملة خاطئة».
إذا اعتبرنا هذه الجملة صحيحة، فهي خاطئة انطلاقا مما تقوله. وإذا اعتبرناها خاطئة فذلك يعني أنها عكسُ ما تقوله: صحيحة. وفي كلتا الحالتين ثمّة تناقض! لذلك لا يمكنُ تقريرُ أنّها صحيحة أو خاطئة.
كان اكتشافُ غودل ثورةً في علوم الرياضيات سمحت بتحديد شريحة من المسائل غير قابلة للحلّ (مثل المعادلات الديوفونسينية Diphonciennes)، ومن العبثِ البحثُ عن طريقةٍ لِحلِّها، أو لِبرمجتها على الكمبيوتر.
من المهمِّ جدّاً، في المنطق وعلوم الكمبيوتر النظرية، برهنة انتماء أي مسألةٍ لهذه الشريحة التي انضافت في رأسها، بفضل تورنغ، مسألةٌ جديدةٌ جوهريّةٌ شهيرة (تسمّى «مسألة توقّف ماكينة تورنغ»):
هل يوجد برنامج كمبيوتر يستطيع أن يُقرِّرَ أن أيَّ برنامجٍ آخر يمكنه أن يتوقّف في لحظةٍ ما، أو أنه سيظلّ يدور في حلقةٍ loopلا تتوقّف؟
إمكانيةُ وجود مثل هذا البرنامج مسألةٌ غير قابلةٍ للحلّ.
فلسفياً، عدمُ قابليةِ حلِّ «مسألة توقّف ماكينة تورنغ»، مثلها مثل عبارة «هذه الجملة خاطئة»، ينبع من أن أي منظومة منطقيّة رسمية، كالكمبيوتر، لا يمكنها برهنة اتساقها من داخلها.
لعلّ الفلاسفة، مثل أرسطو، قد لاحظوا سابقا أن أيَّ خطابٍ بإمكانه أن يلد تناقضات عندما يتحدّث عن نفسه (أي: عندما يكون ذا مرجعٍ ذاتيّ)، كما هو حال «مفارقة الكاذب» الشهيرة:
عندما يقول كاذبٌ: «أنا أكذب» فتصديق أو تكذيب ما قاله يقودان إلى تناقضٍ جليّ.
لِنلاحظ هنا أن وجودَ هذه الشريحة من المسائل غير القابلة للبرمجة لا يعني أن لها حلولاً ميتافيزيقية تتجاوز الفكر الإنساني، أو أن الذكاء الاصطناعيّ قادرٌ على حلِّها يوماً ما، أو أن عدم قابلية حوسبتها يعني أن التفكيرَ الإنسانيّ أرقى من الحوسبة.
كلّا. هي مسائل تنتمي لشريحةٍ لا يمكن، على نحوٍ مطلق، اليوم أو غداً، امتلاك حلٍّ لمسائلها.
يقودنا ذلك الآن للحديث عن العلاقة بين الحوسبة والتفكير.
لننطلق من شكلَي التفكير الذي حدّدهما هايدجر، في محاضرةٍ له في 1955، وهو يتناول تداعيات دخول حوسبةِ الآلة في صلبِ حياتِنا المعاصرة: التفكير المحوسِب la pensée calculante، والتفكير المتأمِّل la pensée méditante.
الأوّل تفكيرٌ يهتمّ بالتنظيم والتخطيط والبرمجة والقياس والتحديد والهندسة والبحث عن الحلّ العمليّ الأجدى والأمثل… والثاني تفكيرٌ في الذات، في المعنى، والعلاقة بالطبيعة والحياة.
الشكل الأوّل للتفكير قابلٌ للحوسبة، حسب أطروحة تشرش – تورنغ، المركزيّة في علوم الكمبيوتر النظرية وفلسفة الذكاء الاصطناعي، التي تنصُّ على أن كلّ ما يمكن حلُّهُ فعلاً من قِبل الإنسان، بطريقةٍ آليّةٍ محدّدة، يمكن برمجتُه في ماكينة تورنغ.
يجدر الإشارة إلى أن هذه الأطروحة ليست نظرية رياضيّةً، لكنها مبدأ فلسفي، أو لنقلْ: فرضيةٌ علميّة أكّدتها الحياة على الدوام، ولا يوجد من يشكّ فيها.
عند الحديث عن الشكل الثاني من التفكير (المتأمِّل)، وإمكانية حوسبته، تتزاحم الأسئلة التي تستحوذ اليوم بشدّة فلسفةَ الذكاء الاصطناعي:
هل السيرورات processus الذهنيّة التي تُنتِجُ التفكيرَ المحوسبَ يمكن حوسبتُها أيضاً؟ هل التفكيرُ المتأمِّلُ وسيرورات انتاجِه الروحيّة التي تشمل الحدسَ، حريّةَ الاختيار، الذكاءَ الإنسانيَّ، وغيرها، قابلةٌ للحوسبة أيضا، كونها جميعاً ابنة الدماغ البشريّ، لأن الإنسان جسدٌ لا غير روحُهُ دماغُه؟ هل الدماغ ماكينةٌ بيولوجيّةٌ يمكن برمجتُها؟ …
تختلف الآراء بطبيعة الحال عند الردّ عليها وإن صار التيّارُ يميل أكثر فأكثر ربما للإجابات الإيجابية على هذه الأسئلة، على المدى البعيد، في عصرنا اليوم الذي أضحت تقنية «التعلّم العميق بشبكات العصبونات الاصطناعية» تحاكي فيه عمل الدماغ البشري وتستقي من ينابيع ذكائه، بل تفوقه في سرعة تواصل شبكاتها وامتلاكها رؤيةً شاملةً لكلِّ التجارب الإنسانية الموجودة في البيانات العملاقة على الإنترنت.
عصرُنا الذي انتقلت فيه أوّلُ صيغ الذكاء الاصطناعي التوليدي: تشات جي بي تي (التي دخلت السوق في نوفمير 2022) من 175 مليار مؤشر paramètre (يحاكي مشابك عصبونات الدماغ synapse) إلى 17 ترليون مؤشر في الصيغة الخامسة، بعد عامين ونصف فقط.
عصرُنا الذي هزم فيه الذكاءُ الاصطناعي بطلَ العالَم جي سيدول، في 2016، في أصعب لعبة منطقية (لعبة ألغو) تفوقُ صعوبةَ لعبة الشطرنج أضعافاً مضاعفة.
هزمه هنا لا كما هزم الكمبيوترُ كازباروف، في 1996، بفضل خوارزمياتٍ بشريّة، بل بالذكاء المطلَق: لعبَ الذكاء الاصطناعيُّ ضدّ نفسه فقط ملايين المرات في بضعة أسابيع، كوّنَ استراتيجيات جديدةً لم تخطر ببال إنسان، وهزم الأخيرَ هزيمةً ساحقة.
صحيحٌ أنّه هنا ذكاءٌ اصطناعيٌّ موجَّهٌ في مجالٍ محدَّدٍ فقط (لعبة ألغو)، إلا أن الأبحاث في الذكاء الاصطناعي «الكليّ» تتقدّمُ يوميّاً، والتقنيات تتطوّر بتسارع وبلا فرامل، لِتزيدَ من أهمية الجدل حول مجموع هذه الأسئلة المفتوحة الخطيرة، المطروحة هنا، واستشرافِ مستقبلها.
لن أدخل الآن في صلب النقطة الثالثة: استشرافُ مستقبل الذكاء الاصطناعي. لي دراسةٌ طويلةٌ عن ذلك في ندوةٍ جامعية عن «سرديات المستقبل» في أواخر سبتمبر ببيروت، بعنوان: «الذكاءُ الاصطناعي وسرديات المستقبل: أيّ عالَمٍ ينتظر البشرية؟»، سيكون لنا عنها حديثٌ لاحق.